في أطراف المدن والأحياء الشعبية وفضاءات الريف المُهمشة، تقوم النساء بملء الفراغ الذي يتركه الاقتصاد الرسمي من خلال أعمالهن غير المرئية وغير المُنظمة، حيث يتقاطع نوعان من العمل النسائي، العمل غير المرئي داخل المنازل بلا أجر أو اعتراف وموجه أساسًا للاستهلاك العائلي، والعمل غير المُنظم الذي يولد دخلاً ولكنه يبقى خارج الإطار الرسمي إذ لا يظهر في الإحصاءات الوطنية ولا يُحسب ضمن الناتج المحلي، رغم أنه يشكّل في الواقع شبكة اقتصادية موازية تُدار من مطابخ البيوت وورش الخياطة المنزلية ومساحات المنازل حيث تُصنع الحلويات والفخار وغيرها من المنتجات المُعدة للبيع من أجل تحقيق الربح.
هذه الأعمال تُمثل نضالات نسائية تسعى لكسر الإهمال المؤسسي وتطرح تساؤلات حول الحاجة إلى نماذج اقتصادية أكثر شمولًا وعدالة، قادرة على احتواء كل الأعمال التي لم يستطع المنوال الاقتصادي الرسمي استيعابها.
الأعمال النسائية في الدفاتر المنسية للدولة
تمثل الأعمال المنزلية جزءًا لا يتجزأ من الشبكة الاقتصادية المخفية التي تنسجها النساء، لكنها تظل مغيّبة عن الحسابات الرسمية وعن أي اعتراف اقتصادي. في هذا الإطار، تُخبرنا نادية، 38 سنة، ربة منزل تقطن حيًا شعبيًا بالعاصمة، عن نضالها اليومي قائلة:
أستيقظ قبل الجميع، أطهو، أنظف، أعتني بالأطفال، وأرافق والدتي إلى الطبيب… أعمل أكثر مما يعمل الرجل الذي يخرج إلى الشارع، ولكن عندما يُقاس العمل، يُقال إن الرجل يعمل وأنا عاطلة.
يشمل هذا العمل الطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال وكبار السن، وهي مهام أساسية لإعادة إنتاج الحياة الاجتماعية، لكنها تُختزل اجتماعيًا في كونها امتدادًا ”طبيعيًا“ للدور الأمومي، لا جهدًا اقتصاديًا يستحق الاعتراف أو الاحتساب.
في المقابل، يختلف العمل غير المُنظم عن العمل غير المرئي من حيث كونه مأجورًا، لكنه يُمارَس خارج الإطار القانوني والرسمي ويفتقر إلى أي حماية اجتماعية. وهو ما ينسحب على صانعات الفخار بسجنان، حيث تمثّل النساء نموذجًا حيًا للعمل النسائي غير المُنظم ذي الجذور الثقافية العميقة. فهن يصنعن بأيديهن أواني وتحفًا فخارية مستوحاة من التراث المحلي، معتمدات على تقنيات تقليدية متوارثة، دون آلات أو وسائل إنتاج حديثة.
ورغم الاعتراف الدولي بفخار سجنان كتراث إنساني لا مادي من قبل اليونسكو، يظل عمل النساء خارج أطر الحماية والتنظيم الاقتصادي، حيث يُسوَّق إنتاجهن بوسائط غير مستقرة ولا يضمن لهن دخلًا قارًا أو اعترافًا مهنيًا يوازي القيمة الثقافية والاقتصادية لما ينتجن.

من جانبها، تُحدثنا صالحة 39 سنة، أم لثلاثة أطفال من منطقة ريفية، عن عملها كخياطة من منزلها، قائلة ”أعمل لجيراني وأهل الحي، لا أمتلك سجلًا تجاريًا ولا أستطيع استئجار محل، أعمل كل يوم وأسعى للكسب وأطمح لتطوير مشروعي لكن ينقصني الدعم“. رغم توفير هذا العمل دخلًا مباشرًا، فإنه يظل هشًا وغير مستقر لغياب التأطير والحماية.
وعلى اختلاف وضعياتهن، تؤدي النساء دورًا اقتصاديًا حقيقيًا لا يُحتسب ولا يُؤطَّر ولا يُعترف به. في هذا السياق، تؤكد الباحثة في الاقتصاد والناشطة النسوية سعاد التريكي، في لقاء مع نواة، على ضرورة الفصل المفاهيمي بين ”العمل غير المرئي“ و”العمل غير المُنظم“، محذّرة من أن الخلط بينهما يُربك فهم الواقع المعقّد الذي تعيشه النساء، خاصة في الأحياء الشعبية والفضاءات الريفية حيث تتقاطع هذه الأشكال من العمل وتتراكم إكراهاتها.
وتوضّح التريكي أن ”العمل غير المرئي هو ذلك الجهد اليومي الذي تقوم به النساء داخل بيوتهن دون أي مقابل مادي، سواء في الطبخ أو التنظيف أو رعاية الأطفال والعناية بالمسنين، وهو عمل موجّه أساسًا للاستهلاك العائلي لا للسوق“. رغم أن هذا الجهد يولّد قيمة اقتصادية واجتماعية أساسية تُسهم في سد حاجيات الأسرة وإعادة إنتاج القوى الحية في المجتمع، فإنه يظل خارج المؤشرات الاقتصادية والحسابات الوطنية، ولا يُعترف به كعمل اقتصادي رسمي. هذا الإقصاء المؤسسي، بحسب التريكي، ”يجعل النساء أكثر عرضة للاستغلال ويحدّ من قدرتهن على الاستقلال الاقتصادي، في ظل غياب أي اعتراف اجتماعي أو قانوني بالقيمة الفعلية لهذا العمل.“
في الوقت الذي تُناقش فيه لجنة الفلاحة داخل البرلمان مشروع القانون المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل تحفّظاته حول هذه الصيغة المُقترَحة الّتي لا تستجيب في نظره لمقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث تمويل المشاريع وكيفيّة تقسيم المرابيح وهيكلة هذه المنظومة الّذي تُعاضد مجهودات القطاعَيْن العامّ والخاصّ في خلق الثّروة. كان لنواة حوار مع لطفي بن عيسى المنسق العلمي للمبادرة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاتحاد العام التونسي للشغل الّذي أتى على هذه النقاط، مؤكّدا ضرورة توضيح المفاهيم وتوحيد النصوص القاونية المنظّمة للهياكل المهنية التي تدخل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل التعاضديات والتعاونيات.
وفقًا لتقرير مؤشر المؤسسات الاجتماعية والجندرية (SIGI 2023)، تقضي النساء التونسيات في المتوسط 5.3 ساعات يوميًا في العمل غير المدفوع داخل المنازل[1]، بينما يقضي الرجال حوالي 0.6 ساعة فقط، أي بمعدل 8.1 مرة أكثر.
وشدّدت التريكي على ”المفارقة التي تكشف مدى هذا التناقض الجندري، فالمرأة التي تُنجز هذه الأعمال داخل بيتها تقوم بها مجانًا، بينما حين يُنتدب شخص خارجي (معينة منزلية) لنفس المهام، يُمنح أجرًا. ومع ذلك، تُطالب المرأة بالاستمرار في هذا العمل، لأنه جزء من ”صورة الأم/الزوجة الصالحة“ التي يرسمها المجتمع ولأن سوق الشغل لا توفر للمرأة سوى نصف حظوظ الرجل في الشغل بالنظر إلى نسب بطالة النساء والرجال في تونس.“
كما توقفت مُحدّثتنا عند وضع النساء العاملات في القطاع الفلاحي، اللواتي يُصنَّفن غالبًا ضمن خانة «المعينات العائليات»، وهو تصنيف تُقصى من خلاله أعمالهن الإنتاجية الفعلية من الإحصائيات الرسمية. فرغم مشاركتهن اليومية في أنشطة إنتاج مباشر، مثل السقي والزراعة وحلب الأبقار وغيرها من الأشغال اليدوية، لا يُعترف بهن كعاملات نشيطات، ولا يُحتسب عملهن ضمن معايير العمل. هذا الإقصاء، بحسب محدثتنا، يحرم النساء من أي اعتراف قانوني أو اقتصادي يضمن لهن استقلالًا ماليًا، في مقابل يتم احتساب صاحب الأرض عاملًا نشيطًا حتى وإن لم يشارك فعليًا في العملية الإنتاجية. ورغم أن الإحصائيات تشير إلى أن النساء يُشكّلن نسبة معتبرة من اليد العاملة الفلاحية في تونس، فإن عملهن يظل غير مرئي وغير مأجور ما دام يُنجز داخل إطار العائلة.
في المقابل، أشارت إلى أن العمل غير المُنظم يختلف تمامًا من حيث طبيعته ووظيفته. فهو عمل مأجور (بأجر)، لكنه يتم خارج الإطار القانوني والجبائي، وعند النساء، كثيرا ما يكون قائمًا على مهارات تقليدية مثل الخياطة، التطريز، الحياكة، أو صناعة الحلويات في المنازل… بهدف البيع في السوق وليس الاستهلاك العائلي، وبالتالي توفر هذه الأنشطة دخلًا مباشرًا لهنّ خارج الاقتصاد الرسمي.

وكشفت دراسة نشرتها وزارة التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 07 أفريل 2021 أن التشغيل غير المُنظم يمثل نحو 36% من مجموع التشغيل، بنسبة 27% لدى النساء مقابل 39% لدى الرجال. ورغم هشاشته، اعتبرت تريكي أن ”هذا النوع من العمل يُعد شكلًا من أشكال المقاومة النسوية اليومية من أجل الاستقلالية المالية، خصوصًا في ظل الانهيار التدريجي لسوق الشغل الرسمي وتقلص فرص التوظيف للنساء خاصة من الفئات الأكثر تهميشا.“
مختلف هذه العوامل تُبقي المبادرات النسائية فردية وموسمية، ما يجعلها عرضة للتلاشي أو الانقطاع عند أول أزمة. ويُعزى ذلك إلى غياب التشبيك، وانعدام الدعم الفني والمالي، وعدم توفر مسارات واضحة للانخراط في الدورة الاقتصادية. وبالتالي، فالنساء العاملات في الخفاء يخلقن ”فرصا للبقاء، لكن ضمن شروط غير مُنصف.“، بحسب التريكي.
قصور بنيوي في تمثّل أدوار النساء
أمام محدودية وتعثر الآليات الرسمية للاعتراف بالعمل النسائي غير المرئي وغير المُنظم، توقفت الأستاذة الجامعية والباحثة ليلى الرياحي، عضو المجلس الاستشاري في شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عند نقائص قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني [2] في تونس، مشيرة إلى أن القانون لم يُشر صراحة إلى النساء، ولم يعتمد أي مقاربة جندرية، كما لم يمنح فئة النساء العاملات في العمل غير المرئي اعترافًا بالأطر التي ينشطن داخلها، معتبرة أن هذا الغياب يعكس قصورًا بنيويًا في تصور القانون للفئات الهشّة المعنية به. وبيّنت في تصريح لـنواة أن:
منح مكانة حقيقية للعمل غير المُنظم للنساء لا يتحقق بمجرد وجود إطار قانوني، بل عندما تتمكن النساء من التنظم في أطر تعاونية تتيح لهن السيطرة على دورة الإنتاج وإعادة الإنتاج، والنفاذ إلى الموارد وإضافة قيمة فعلية لعملهن، بما يسمح بخلق قيمة مضافة وتحسين أوضاعهن الاقتصادية.
وتعتبر الرياحي أن ”القانون لا يُعد عنصرًا محددًا بقدر ما يمكن أن يكون عاملًا مُسهِّلًا، متى ساعد على تنظيم النساء داخل دورة الإنتاج، واحتساب العمل، والمشاركة في الأصول، وإعادة توزيع الأرباح بشكل عادل. غير أن ذلك، بحسب تقديرها، لم يتحقق في التجربة التونسية.“
وفي سياق اتساع رقعة الاقتصاد غير المُنظم في تونس، لفتت الرياحي إلى أن:
قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حتى وإن طرح بعض هذه الإشكاليات، لم يحدّد الآليات الكفيلة بتطوير فكرة التعاون ولا بإخراج النساء من وضعية العمل غير المُهيكل، بل تم، في المقابل، ”السطو“ على هياكل كانت تحمل بعض خصائص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإعادة تدويرها دون تحقيق فائدة حقيقية للفئات المعنية.
بدوره يعتبر حسين الرحيلي، الباحث الأكاديمي المختص في التنمية والتصرف في الموارد، أن ”أحد أبرز أعطاب قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس هو إغفاله التام للبعد الجندري، رغم أن هذا النمط الاقتصادي وُجد تاريخيًا لاحتضان الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها النساء العاملات في الاقتصاد غير المرئي وغير المُنظم.“
ويشير الرحيلي في حديثه لـنواة إلى أن:
قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الصادر سنة 2020 لم يُقدَّم كأداة لإدماج النساء وتمكينهن اقتصاديًا، بل جرى تحميله بشكل تسويقي مسؤولية تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، وهو ما اعتبره تشويهًا لمفهوم الاقتصاد الاجتماعي ذاته وبالتالي لا يمكن لهذا النمط الاقتصادي أن يعوّض دور الدولة في العدالة الاجتماعية، بل يفترض أن يكون آلية لخلق الثروة الجماعية في إطار اجتماعي أكثر توازنًا، يضمن الكرامة الاقتصادية للفئات المهمشة.
ويشدّد الرحيلي على أن التجارب النسائية لا تُبنى بالقوانين وحدها، بل من خلال تطوير الكفاءات، وتوسيع مجالات تدخل النساء، وعدم حصرهن في أطر نمطية ضيقة. في هذا الإطار، يقارن بالتجربة المغربية، حيث نجحت التعاونيات النسائية في مجالات الصناعة والتحويل والتجميل والبيئة، مثل تعاونيات زيت الأرغان في منطقة سوس بين مراكش وأغادير حيث منحت هذه المجالات النساء تميّزًا اقتصاديًا وحصرية إنتاجية، بفضل سياسات عمومية اعترفت بدورهن وقدّمت لهن الإطار المناسب لدعم إنتاجهن ومهاراتهن.
على خلاف السياق التونسي، تظهر الأرقام من المغرب مثالًا على توسّع أُطر التعاونيات في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واندماجها في البنية التنموية الرسمية. إذ تضم الشبكة هناك أكثر من 61 ألف تعاونية تجمع نحو 800 ألف متعاون ومتعاونة، من بينهم نحو 8 آلاف تعاونية نسائية، حسب بيانات كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب.
في المقابل، يرى الرحيلي أن الدولة التونسية لم تعمل على تأهيل النساء أو صناعة هذه الكفاءات، بل دفعت بهن نحو أنشطة محدودة القيمة المضافة، مما أبقى العمل النسائي حبيس الهشاشة، حتى داخل الأطر القانونية الجديدة.

تجارب اقتصاد اجتماعي تضامني مُنفصلة عن المجتمع
تُعرف شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني بأنه نمط اقتصادي يقوم على تمكين الشعوب من ابتداع أدوات إدارية للاقتصاد تمكنها من إدارة مواردها وتحقيق أهدافها وتطلعاتها بالتوافق التام مع بيئتها الطبيعية وتاريخها الثقافي والاجتماعي.
ويقوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني على ستة مبادئ أساسية، هي: المسؤولية الذاتية، المساعدة الذاتية، التضامن، الديمقراطية، الإنصاف، والمساواة. إلا أن التجارب التونسية توثق تجاهلا تاما لهذه المبادئ.

ويُعزى هذا الفشل، وفق دراسة بعنوان ”الاقتصاد الاجتماعي التضامني، آلية مقاومة“ لحسين الرحيلي (أكتوبر 2020)، إلى تدخل الدولة والسلطة المركزية بشكل مفرط، والإلزامية في الانخراط، والرقابة المشددة على نشاطات المؤسسات التضامنية، ما أفقدها الطابع الطوعي والاستقلالية، وهو أحد المبادئ الجوهرية للاقتصاد الاجتماعي التضامني عالميًا. وقد شهدت تونس منذ الستينات عدة تجارب في هذا المجال، بدءًا بتجربة التعاضد، مرورًا بالتعاونيات الزراعية ومجامع التنمية الفلاحية، وصولًا إلى الشركات التعاونية والخدماتية والجمعيات التنموية بعد الثورة، إلا أن هذه التجارب بقيت محدودة التأثير.
وتشير ذات الدراسة إلى أن ضعف الحوكمة وغياب التسيير الديمقراطي والشفافية أدى إلى سيطرة الطابع العائلي والعشائري على كثير من الهياكل، ما أثر على فعاليتها، في حين كانت الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة ضعيفة بحيث ولم تُسهم فعليًا في التنمية الوطنية أو التشغيل، خاصة في ظل قلة التمويل العمومي ونقص الإحاطة الفنية، ما تسبب في إهمال أو إفلاس العديد من المؤسسات، لا سيما مجامع التنمية الفلاحية.
علاوة على أن تعدد وتداخل أجهزة الرقابة والإشراف أوجد طبقة بيروقراطية خانقة، حُوّلت هذه المؤسسات في كثير من الأحيان إلى أدوات للتوظيف السياسي أكثر من كونها آليات لتطوير الاقتصاد التضامني. وفي المجمل، تعكس هذه المعطيات محدودية مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس، إذ لا تتجاوز مساهمته في الاقتصاد الوطني 1.2% في أحسن الأحوال، ويظل عدد المنخرطين محدودًا، ما يوضح فشل التجربة في الانغراس الاجتماعي والاقتصادي رغم المحاولات القانونية والتنموية المختلفة. وفق ذات الدراسة.

الشركات الأهلية: إرث من الفشل المُعاد تدويره
رغم النفخ السياسي المكثّف في خيار الشركات الأهلية [3]كبرنامج اجتماعي شعبي وتقديمه كرافعة للتنمية المحلية والجهوية، تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني محدودية النتائج إلى حدّ يفرغ المشروع من مضمونه الاقتصادي. فإلى حدود 10 نوفمبر 2025، لم يتجاوز عدد الشركات الأهلية المُحدثة 230 شركة، من بينها فقط 60 شركة دخلت طور النشاط الفعلي، أي أقل من ثلث الإجمالي، وهو مؤشر صريح على ضعف قابلية هذه الصيغة للاستدامة. أما على مستوى التشغيل، فقد أفضت كل هذه المنظومة، بكل ما رُصد لها من امتيازات قانونية ومالية وعقارية وجبائية، إلى إحداث حوالي 380 موطن شغل فقط، أي بمعدل لا يتجاوز 6 مواطن شغل للشركة الواحدة الناشطة، وهو رقم هزيل إذا ما قورن بحجم الموارد العمومية المسخّرة لفائدتها.
الأخطر من ذلك أنّ هذه النتائج المتواضعة تحقّقت رغم ما حظيت به الشركات الأهلية من تسهيلات غير مسبوقة، شملت إعفاءات جبائية لعشر سنوات، وتوقيف الأداء على القيمة المضافة، وإتاحة قروض بنسب فائدة تفاضلية مضمونة من الدولة، إلى جانب تمكينها من أراضٍ فلاحية دولية وأملاك الدولة الخاصة واستغلال الموارد الغابية، فضلًا عن تبسيط جذري لإجراءات التأسيس عبر تخفيض عدد المؤسسين ورأس المال المطلوب. ومع ذلك، لم تُفضِ هذه الامتيازات إلى خلق قيمة مضافة حقيقية، إذ ظلّ نشاط أغلب الشركات الأهلية محصورًا في حلقات وسيطة ضعيفة الإنتاجية، تقوم على إعادة توزيع هامش الربح لا على إنتاج الثروة، كما هو الحال في بيع المنتجات الفلاحية أو المواد الأولية دون أي تحويل صناعي.
وفي هذا السياق، يوضح الباحث حسين الرحيلي أن ”معظم الشركات الأهلية لا تنتج القيمة بل تكتفي بتقسيمها، حيث أنّ الشركة التي تقتصر على جلب أكياس الأمونيتر (السماد الفلاحي) وإعادة بيعها بالكيلوغرام للفلاحين لا تدخل أي حلقة تحويل أو تصنيع أو تطوير، بل تظلّ أسيرة نفس الحلقة التجارية البسيطة. ويؤكد أن هذا النمط لا يُعدّ استثناءً، بل ينسحب على أغلب الشركات الأهلية التي اقتصرت أنشطتها على الفلاحة الخام دون أي توجّه نحو التصنيع أو التحويل أو الابتكار، وهو ما يفسّر ضعف القيمة المضافة، التي تكاد تكون شبه معدومة، في هذه التجارب.“

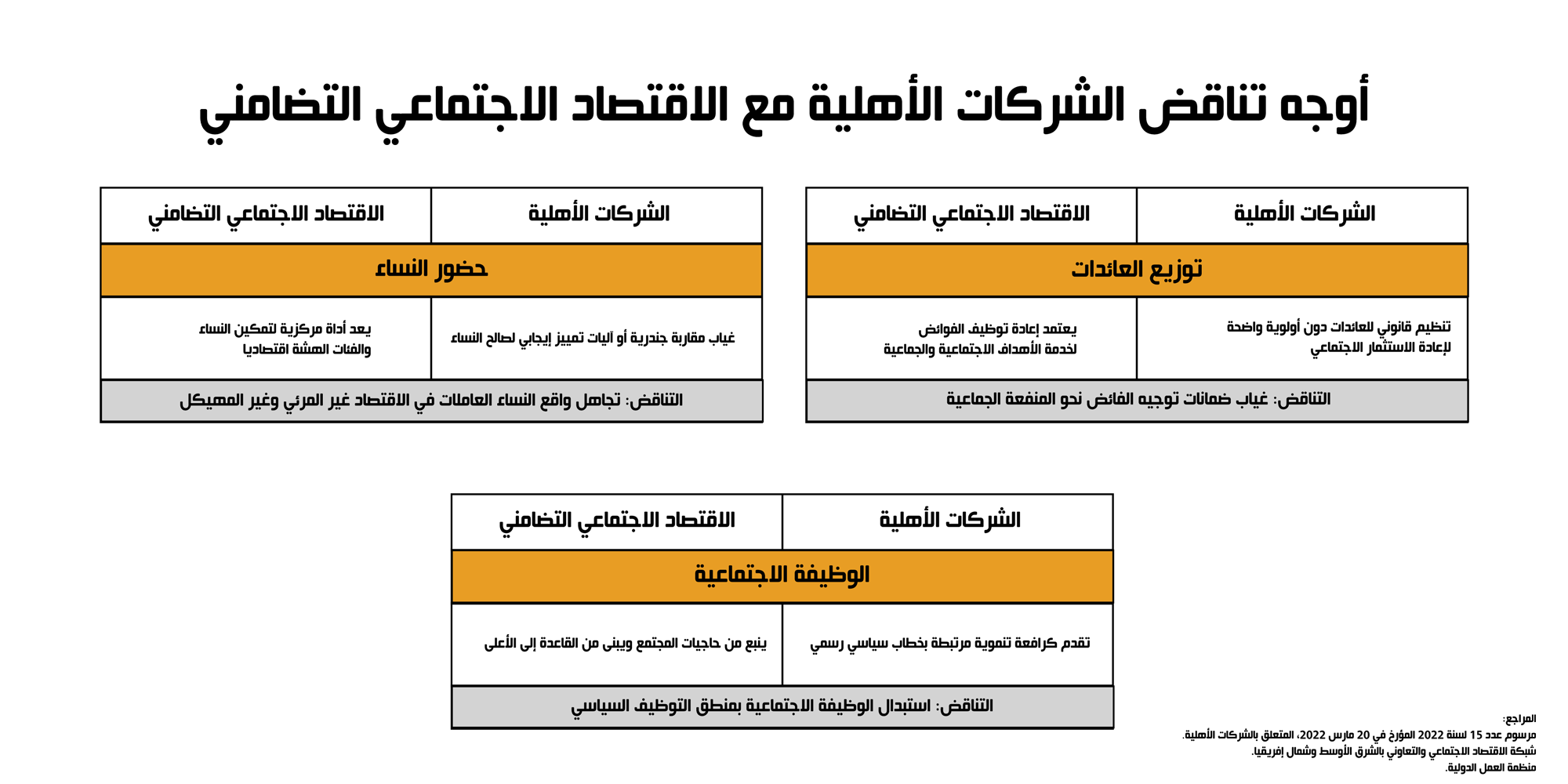
كل ذلك يجعل من هذه الأرقام انعكاسا لفشل بُنيوي لا يمكن تبريره بعوامل ظرفية، بل يرتبط بطبيعة المشروع نفسه باعتباره خيارًا فوقيًا مُسقطًا على المجتمع، لا يستند إلى ديناميكيات اقتصادية قائمة ولا إلى حاجيات اجتماعية حقيقية. فالمعضلة في تونس لا تكمن في شكل الشركة أو عدد المؤسسين، بل في منوال تنموي مأزوم يعيد إنتاج نفس السياسات الفاشلة تحت تسميات جديدة. وعليه، يبدو أن إصرار السلطة على إحياء برنامج الشركات الأهلية، لا يعدو أن يكون إلاّ محاولة لتجميل فشل مزمن في خلق الثروة وتحقيق التنمية الفعلية.
تبعا لذلك، يعتبر الباحث حسين الرحيلي أن تجربة الشركات الأهلية يمكن تصنيفها، عمليًا، كتجربة فاشلة بعد مرور ثلاث سنوات فقط على إقرارها، وهو فشل لم يعد ضمنيًا بل جرى الإقرار به رسميًا عبر تنقيح المرسوم المنظم لها في أكتوبر 2025. والذي لا يُقرأ كتحسين تقني، وإنما يمثّل في جوهره اعترافًا ضمنيًا بأن الصيغة الأصلية لم تُنتج الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي رُوّج لها. إذ انتقل شرط تأسيس الشركة من خمسين منخرطًا إلى عشرة على المستوى المحلي وخمسة عشر على المستوى الجهوي، في محاولة لإنقاذ نموذج لم ينجح في استقطاب المجتمع أو خلق مبادرات ذات معنى اقتصادي حقيقي.
ويضع الرحيلي هذا الفشل ضمن سياق أوسع من تكرار التجارب ذاتها في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس، حيث لا تزال البلاد، منذ الستينات، تعيد استنساخ نفس الأشكال المرتبطة بتجربة التعاضد، التي انحصرت أساسًا في المجال الفلاحي الريفي، ثم التعاونيات ومجامع التنمية الفلاحية، وصولًا إلى الشركات الأهلية اليوم، دون توسيع مجالات التدخل نحو الصناعة أو البيئة أو تحويل المواد الفلاحية، ويستدعي في هذا السياق الإشارة إلى تجربة التعاضد في الستينات كمرجع تاريخي تأسيسي، انتهى هو الآخر إلى الفشل بسبب تدخل الدولة وغياب الطابع الطوعي والاستقلالي.
ويحذّر الرحيلي من أن حجم الامتيازات المالية والجبائية الممنوحة للشركات الأهلية، في ظل ضعف القيمة المضافة وغياب الرقابة الفعلية، يفتح الباب أمام مخاطر جدية تتعلق بسوء التصرف في المال العام أو حتى تبييض الأموال، خاصة في ظل إعفاءات جبائية تمتد لعشر سنوات. ويستند في ذلك إلى تجارب سابقة عرفتها تونس، مثل قوانين تشيجيع الاستثمار لسنة 1972 و 1974 ومجلة الاستثمارات لسنة 1993، حيث استُخدمت الامتيازات كآلية لفتح شركات مؤقتة تتمتع بالإعفاءات، ثم تُعلن إفلاسها فور انتهاء فترة الامتياز، لتُعاد بعثها تحت تسميات جديدة، دون تحقيق تنمية أو تشغيل مستدام.
يعمل قيس سعيد على دفع هياكل الدولة إلى توفير التسهيلات والإعفاءات اللازمة تحفيزا للانخراط في مشروعه الاقتصادي، الشركات الأهلية، تسهيلات أثارت جدلا في الأوساط الاقتصادية لاقتصارها على هذه الشركات دون غيرها. في هذا الإطار، حاورت نواة حسام سعد عضو منظمة آلرت للحديث عن حقيقة دور الشركات الأهلية في التنمية وانعكاس محاباة السلطة لباعثي هذه الشركات على الدورة الاقتصادية.
من جانبها، اعتبرت الأستاذة الجامعية والباحثة ليلى الرياحي أن الشركات الأهلية نموذج يسهل توظيفه في الزبونية السياسية. وأوضحت أن القانون الخاص بالشركات الأهلية لا يعرّف العمل ولا الموارد، ولا يضعهما في صلب العملية الإنتاجية، بل يكتفي بالحديث عن الاكتتاب في رأس المال وآليات التسيير. وأضافت أن منظومة الحوكمة داخل هذه الشركات غير ديمقراطية وليست في يد العمال أو المنتجين، وهو ما يجعلها بعيدة عن أطر الحركة التعاونية كما هي معتمدة عالميًا، والتي تقوم أساسًا على السيطرة الجماعية على الإنتاج، والاستقلالية، والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرار. وخلصت إلى أن هذا النموذج لا يوفّر شروط تنظيم العمل، ولا يخلق مسارات حقيقية لتمكين النساء العاملات في الاقتصاد غير المرئي وغير المُنظم من الخروج من الهشاشة أو من امتلاك أدوات إنتاجهن بشكل جماعي.
في المحصلة، يكشف هذا المسار أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس ظلّ تاريخيًا وصولًا إلى الشركات الأهلية اليوم، رهين التوظيف السياسي، واليوم، في ظل تصاعد الشعبوية، بات هذا النموذج واجهة دعائية لسلطة لم تنجح في الاستجابة لتطلعات التونسيين الاقتصادية. في مقابل هذا الإخفاق، تواصل النساء في أطراف المدن والأرياف مقاومتهنّ اليومية عبر أعمال غير مرئية وغير منظَّمة، تشكّل، رغم هشاشتها، شبكات اقتصادية حقيقية.
[1] منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية / مؤشر المؤسسات الاجتماعية والجندرية (SIGI). (2023). الملف الوطني: تونس. OECD / UN Women
[2] مصدر: قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رقم 2019/79 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، صادق عليه مجلس نواب الشعب التونسي في 17 جوان 2020
[3] المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، المتعلّق بإحداث الشركات الأهلية





المرأة في تونس قسمان ثلة وقلة. أما القلة فهي امرأة استجملت تعتني بقضايا لا صلة لها، لا بالمجتمع ولا بمشاغله، امرأة كأنها تعيش في كوكب آخر ترى أن الحياة لا تتم إلا على النمط الغربي الواطي وان الحياة لا تتم إلا بتطهير الأرض من الرجال و ان كان بعض الرجال عبء على الأرض. هذه القلة تسمع لها جعجعة ولا ترى طحينا الا ما زاد عن المجاز. أما الثلة من النساء اللاتي نجدهن في الريف وفي الأحياء الشعبية، في العمل الفلاحي و في عمل المصانع فهن كادحات لا تمللن ولا تكلن نساء المرأة بجبل. ولكن تعشن في الواقع وترى انها والرجل على الدنيا و في الكثير من الحالات لا يعطيها لا الرجل ولا المجتمع ولا الدولة حقها اما القلة الصاخبة فهي ترى أنها والحياة على الرجل. تحية إجلال وتقدير وعرفان لكل امرأة من الثلة.